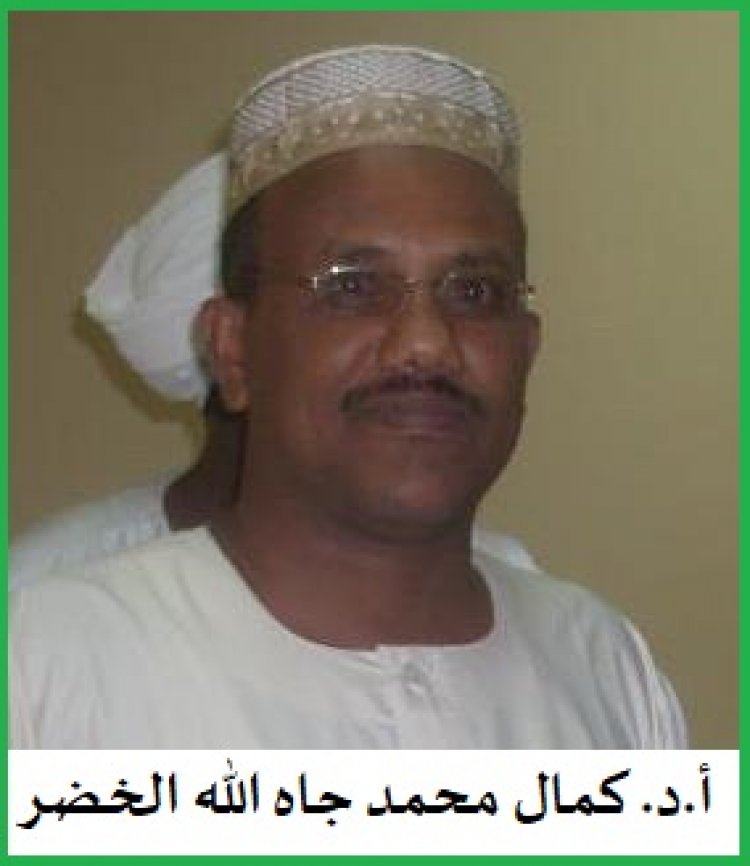إسهام علماء إفريقيا جنوب الصحراء في تفسير القرآن الكريم

"كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، للشيخ عبد الله بن فودي نموذجا
بقلم الأستاذ الدكتور/ كمال محمد جاه الله الخضر
منذ دخول الإسلام إلى مناطق إفريقيا جنوب الصحراء بدولها المختلفة التي تقاسمتها، استعماريا، دول أوروبا بعد مؤتمر برلين الشهير (١٨٨٤/ ١٨٨٥م) - وحتى يوم الناس هذا، شهدت حركة تأليف واسعة في شتى العلوم الإسلامية، تأسيا بما كان يحدث من حركة تأليفية في المشرق العربي، وفي شمال إفريقيا، وملازمة لما تم في شرقها.
وإن جولة في المدن التاريخية القديمة، مثل: تمبكتو وجِني وغيرهما- تكشف عن آلاف المخطوطات، التي تنتظر من يتصدى لها دراسة وتحقيقا، والتي يقف خلفها علماء أفارقة أجلاء، أظهروا براعة، وريادة في التأليف في مختلف علوم عصرهم نثرا وشعرا- علماء لا يعرف عنهم، ولا عن منجزاتهم العلمية الكثير في عالمنا العربي والإفريقي.
وللأسرة الفودية في غرب إفريقيا (نيجيريا الحالية على وجه التحديد)، لا سيما عَلَمَيْها، الشيخ عثمان بن فودي، وأخوه الشيخ عبد الله بن فودي- إسهامات مهمة في مجال اللغة العربية، وفي مجال العلوم الإسلامية، وفي مجال الفكر الصوفي، وفي مجال الفكر السياسي... إلخ. يدل على ذلك كثرة المؤلفات المختلفة التي أنجز ممن ينتمون إلى هذه الأسرة المتميزة، في محيطها الإقليمي، باللغات: العربية والفولانية والهوسوية.
سنحاول في هذا المقال المختصر، إلقاء الضوء حول كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، للشيخ عبد الله بن فودي، باعتباره نموذجا معتبرا لإسهام علماء إفريقيا جنوب الصحراء، في مجال تفسير القرآن الكريم، وهو مجال، علاوة على أنه من أفضل العلوم، وأهمها لتعلقه بكلام الله عز وجل، وأنه يعين على فهم معاني القرآن، وترسيخها في الأذهان- يعد من أصعب المجالات التي لا يقتحمها، إلا من توافرت له أدوات عزيزة المنال، من لغة وبصيرة وقراءات متعمقة في مصادر التراث التفسيري العربي والإسلامي، علاوة على قدرة على الاستنباط والفهم، وغير ذلك من الأدوات الواجب توافرها في المفسر، لهذا الكتاب العزيز.
الشيخ عبد الله بن فودي، نبذة عن حياته وتعليمه:
إن التعريف المفصل للشيخ عبد الله بن فودي- هو أبو محمد، ويقال أبو الحسن، عبد الله بن محمد الملقب بفودي، ومعناه: الفقيه باللغة الفولانية، ابن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد الملقب، بن جُبُّ بن محمد ثَبْنُ بن أيوب بن ما سَرانَ بن بُوبَ بابَ بن موسى جَكَلُ. وأمه هي حوّاء بنت محمد بن عثمان بن جَمِ بن عال بن جُبُّ بن محمد ثَنْبُ بن ماسران بن بُوبَ بن موسى جَكَلُ. ويلتقي مع أمه في الخامس له، والرابع لها.
وأما قبيلته، فينسب إلى قبيلة فلانية هاجرت من شمال إفريقيا إلى أقاليم فُوتا تُرو، وفُوتا جالُون في موقع السنغال وغينيا الحاليين منذ زمن طويل. واستقرت بهذين الإقليمين زمنا طويلا، ثم رحل جزء منها إلى جهة الشرق، وعاشوا في مواطن القبائل الهوسوية، وذلك في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي تقريبا، وكان أجداد عبد الله من بينهم؛ لذلك لا يستغرب جمع الأسرة الفودية بين اللغتين: الفولانية (الفلفدي) والهوسا.
وأما فيما يخص مولده ووفاته- فقد اختلفت الروايات الواردة في تاريخ ميلاد الشيخ عبد الله ووفاته، وتضاربت الأقوال في ذلك، فذكر الشيخ أبو بكر محمد غومي أنه: "ولد الشيخ عبد الله بن فودي سنة ألف ومائة وتسعة وسبعين هجرية (١١٧٩هـ- ١٧٦٥م)، وتوفي وهو ابن ست وستين سنة، أول خمس وأربعين ومائتين بعد ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل السلام (١٢٤٥هـ- ١٨٢٩م). وذهب الشيخ آدم عبد الله الألوري إلى أنه ولد سنة (١١٧١هـ- ١٧٥٨م)، وتوفي سنة (١٢٤٤هـ- ١٨٢٨م). وقيل غير وذلك، ولكن الشيخ نفسه ذكر في كتابه: "تزيين الورقات"، أنه يصغر أخاه الشيخ عثمان بنحو اثنتي عشرة سنة. وعلى هذا يكون تاريخ ميلاده ١١٨٠هـ، الموافق ١٧٦٦م؛ لأنه من المعلوم تاريخيا أن الشيخ عثمان ولد سنة ١١٦٨هـ (١٧٥٤م).
ولد الشيخ عبد الله في منطقة "غوبر" في عائلة (آل عال)، من حي "التورب"، وهو حي قد عرف بأنه كان محمل الثقافة الإسلامية، وينشرها حيثما حلّ. وتعتبر عائلة الشيخ المباشرة نموذجا حيا في هذا المجال؛ وذلك لارتباطها بالثقافة الإسلامية ارتباطا وثيقا، ولعملها المعروف على نشرها.
حفظ الشيخ عبد الله القرآن الكريم على يد والده، وهو ابن ثلاثة عشر عاما، ثم عهد إلى أخيه الشيخ عثمان، وهو ابن خمس عشرة سنة، فأحسن تأديبه وتربيته، ومنذ ذلك الوقت لم يفارق الشيخ عبد الله أخاه على مدى ما يقارب الأربعين سنة، كان فيها الساعد الأيمن له، والصديق الوفي في الحل والترحال.
نشأ الشيخ عبد الله بن فودي في بيت ممتد عرف بالصلاح، وذاعت فيه التقوى والورع، كابرا عن كابر، فتربى في بيئة متدينة تلتزم بأوامر الله، وتنتهي بنواهيه، وتتمسك بدينه، فهو عالم متميز، عاش وترعرع وسط مهتمين بالتربية الإسلامية منذ نعومة أظافره.
وقد كان الشيخ عبد الله بن فودي مجاهدا كبيرا في حركة الإصلاح، التي قادها أخوه الشيخ عثمان بن فودي في بلاد الهوسا، وهو أول من بايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره.
وعن شيوخ عبد الله بن فودي- يرى عمر أحمد سعيد- أنه مما يلاحظ بعد الاطلاع على "إبداع النسوخ" و"تزيين الورقات"، وغيرهما من مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي- هو تعدد شيوخه وتعدد مصادره، ومن ثم اتساع ثقافته، التي يمكن تلخيصها في بضعة محاور، على النحو التالي:
١- ثقافته في مجال اللغة العربية.
٢- ثقافته في مجال العلوم الإسلامية.
٣- ثقافته الصوفية.
٤- ثقافته التعليمية.
الحق أنه بالنسبة للشيخ عبد الله- فقد كان أمر الشيوخ عنده معظما بدرجة كبيرة... ويكمن اهتمام الشيخ عبد الله بالشيوخ، وتعظيمه لهم في إيمانه القاطع بأن الاستقامة في الدين لا تأتي إلا بشيخ صالح... والمطلع على مؤلفات الشيخ عبد الله الخاصة بتاريخ الجهاد- يلاحظ أن الشيخ جبريل، والشيخ عثمان- يمثلان قطبين رئيسيين في تكوين شخصيته، وخلفيته العلمية، والروحية.
قرأ الشيخ عبد الله القرآن الكريم على يد أبيه، ثم انتقل إلى أخيه الأكبر الشيخ عثمان، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، كما تمت الإشارة من قبل- فقرأ عليه العشرينيات (وهو نظم تخميس الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، تأليف: أبو بكر بن المهيب رحمة). وهذا الكتاب مشهور يدرس في كتاتيب نيجيريا، والشعراء الستة، وأخذ منه علم التوحيد، والإعراب من الآجرومية والملحة والقطر ونحوها وشروحها ثم أخذ من علم التصوف والفقه والتفسير. ودرس بعض علوم اللغة العربية على أيدي عمّه عبد الله بن محمد بن الحاج، وعلى ابن خالته محمد بن محمد، الذي درس عنده مقامات الحريري وغيرها، ودرس البلاغة على يدي الشيخ أحمد بن أبي بكر بن غار، ودرس مع أخيه عثمان على يدي العالم الجليل المجاهد جبريل بن عمر، وارتحل لطلب العلم وتحصيله إلى البلدان المجاورة والقاصية، ولم يتوقف الشيخ عبد الله عند هذا الحد، بل كان يكتب إلى الشيوخ والعلماء في بلاد السودان الغربي يطلب مؤلفاتهم، وكتبهم المفضلة، وكان دؤوبا على العلم وتحصيله.
يدل ما سبق ذكره على حرص الشيخ عبد الله على التعلم، وعلى تعدد مصادره التكوينية، بحرصه على التواصل مع شيوخ علم مختلفين، في مجالات العلم المختلفة من أسرته وغيرها. لقد سعى سعيا متصلا إلى التعلم مباشرة منهم، أوالتتلمذ على مؤلفاتهم وكتبهم؛ فتكونت له شخصية ثرة في مجالات: اللغة العربية والعلوم الإسلامية المختلفة وغيرها من العلوم؛ مما سينعكس لاحقا عن شخصيته كمؤلف متنوع الإنتاج العلمي، وغزيره.
الشيخ عبد الله بن فودي ومؤلفاته:
في البدء، قال عن مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي- مَن كتب أطروحة مهمة عن الثقافة العربية في نيجيريا، وهو الدكتور/ علي أبو بكر- قال: "إن البلاد لتفخر بمؤلفات هذا العبقري، لا لكثرتها وقيمتها فحسب، ولكن لشمولها لمعظم العلوم من تفسير، وفقه، وتصوف، وتاريخ، وحديث، ونحو، وصرف، ومنطق، وعلم الكلام، وعروض، وأدب... ولا شك أنه كان أكبر عالم، وكاتب عرفته إفريقية الغربية أو يمكن أن تعرفه. فلا غرابة أن يلقبه الناس بعربي السودان لمجهوده الجبار، وفضلا عن ذلك فهو شاعر مُفلِق، وقائد بارع، وسياسي محنك.
لقد أنعم الله على الشيخ بنعم كثيرة، منها علمه، الدالة عليها كثرة مؤلفاته، التي بلغت أكثر من مائة وسبعين مؤلفا في مختلف الفنون الإسلامية، ما بين كتاب ورسالة، موزعة بين كل فروع العلم والمعرفة في عصره، مع ما هو فيه من الأشغال الشاقة في وقت الهرج، وقلة الراحة؛ بسبب انتظامه في حركة الجهاد، التي قادمها ردحا من الزمن أخوه الشيخ عثمان، وهي فترة بما فيها من انشغالات، كانت كفيلة بأن تقف حجر عثرة في طريق حياته كمؤلف بارع.
المهم أن للشيخ عبد الله من الكتب في التفسير وفنونه: "ضياء التأويل في معاني التنزيل"، و"الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة"، و"مفتاح التفسير"، و"سلالة المفتاح"، و"كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"...إلخ، وفي الفقه الإسلامي وأصول الفقه والسياسة الشرعية له: "خلاصة الأصول في علم الفقه"، و"ضياء الأمة في أدلة الأئمة"، و"اللؤلؤ المصون"، و"الترغيب والترهيب"، و"ضياء الأنام في الحلال والحرام"، و"وضوء المصلي"، و"ضياء السياسات"، و"فتاوى النوازل مما هو في الدين من المسائل"، و"ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من أحكام"...إلخ، وفي اللغة العربية له: "الحصن الرصيف في علم التصريف"، و"البحر المحيط"، و"لمع البرق في الإعراب"، و"فتح اللطيف الوافي لعلمي العروض والقوافي"...إلخ، ومن مؤلفاته في التاريخ والسير (وقد كانت بالشعر والنثر): "تزيين الورقات بجمع بعض ما لي من الأبيات"، وهو أشهرها، وغير ذلك من المؤلفات المختلفة، التي تصل إلى نحو المائة والسبعين مؤلفا؛ مما يدل على ريادته الأدبية والعلمية.
ويعد جانب العلوم الإسلامية، وهو مجال فسيح، يشتمل على أصول العلوم من تفسير، وحديث، وفقه، وسيرة، وتوحيد، وغيرها- أكبر الجوانب التي أسهم فيها الشيخ عبد الله كما كيفا؛ وذلك لاهتمامه الواضح بنشر هذه العلوم في بيئته من جهة، ولما يترتب على هذا الاهتمام من غزارة إنتاجه فيها من جهة أخرى.
ومن إسهامات الشيخ عبد الله في العلوم الإسلامية إسهامه في علوم التفسير.. وبما أن الشيخ عبد الله يعتبر علم الشريعة علمه الأول، ومجال تخصصه الرئيسي، فإن إسهاماته في مجال التفسير كان في الحقيقة إسهاما كبيرا لا يقل عن إسهامه في مجالات الشريعة، إن لم يكن أكبر منه. لذلك سنتطرق إلى هذا الإسهام بالتفصيل في محور لاحق من هذا المقال.
في مجال التأليف، عموما- تأثر الشيخ عبد الله، وهو مالكي المذهب، كغيره من علماء غرب إفريقيا وبلاد السودان- بعدد من علماء المذهب المالكي، خاصة المغاربة. ولهذا جاءت مؤلفاته في الفقه متأثرة بكتاباتهم، وكثير منها تلخيص مباشر أو غير مباشر لمؤلفات هؤلاء العلماء. ولعل من أشهر علماء الفقه، الذين تأثر بهم الشيخ عبد الله العالم المغربي أحمد بن محمد العبدلي، المعروف بابن الحاج، خاصة في كتابه "المدخل"، الذي يعد مصدرا رئيسيا من مصادر الشيخ عبد الله في الفقه. وقد ألّف على غراره كتابه المشهور "لباب المدخل"، وهو من أهم كتب الشيخ عبد الله في مجال الشريعة- تناول فيه القضايا الفقهية، وقضايا السياسة الشرعية في منطقة هوسا.
وللشيخ عبد الله أيضا كتاب آخر في الفقه يماثل "لباب المدخل"، من جهة كونه قد أخذ مادته من أحد علماء المغاربة أيضا، ومادته ذات طابع فقهي، وهو كتاب "النصائح في أهم المصالح"، الذي أخذه عن "النصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية" لأحمد الزروق. وفي هذا الكتاب تناول العديد من الأحكام الفقهية في الكثير من القضايا المتعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرها، وبنفس الطريقة يفرد الشيخ فصلا في آخره للكلام عن قواعد التصوف، وقضاياه من الناحية الفقهية، وغير ذلك من الكتب والرسائل، التي أسهم فيها في مجال الفقه، التي منها: "النصيحة فيما يجب على المكلف"، و"ضياء الأنام في الحلال والحرام"، و"العبادات على سنة الرسول وتابعيه من السادات".
أما في مجال أصول الفقه- فقد جاءت إسهامات الشيخ عبد الله تعليمية بحتة، وذلك لطبيعة علم أصول الفقه الجافة باعتباره علما للخاصة- يشتمل على العديد من أصول ومباديء وقواعد لا بد من حفظها مثل: علم النحو والعروض وغيرهما. ولعل من أهم مؤلفات الشيخ عبد الله في علم الأصول كتابه المنظوم من ألف بيت المسمى "ألفية الأصول وبناء الفروع عليها"، وهو نظم لكتابه المسمى "مفتاح الأصول" لعالم تلمسان محمد أحمد السني الحسني.
وأما فيما يخص السيرة النبوية والشمائل المحمدية- فإن الشيخ عبد الله قد عني بسيرة الرسول وبيان أخلاقه وشمائله- باعتبارها ثقافة مهمة للمسلم، لا بدّ من الاطلاع عليها بغرض التأسي بها، تكشف ذلك مؤلفاته: "رسالة أخلاق المصطفى"، و"تعليم الأنام بتعظيم الله لنبينا عليه الصلاة والسلام"، و"علامات المتبعين"، وغيرها.
وبجانب إسهامات الشيخ عبد الله في العلوم الآنفة الذكر- فقد أسهم في علوم أخرى عديدة من العلوم الإسلامية، فهو في علم الحديث قد ألف منظومة سماها "سراج الجامع للبخاري"، تناول فيها كتاب "الجامع الصحيح" للبخاري؛ مما يشير إلى طول باعه في هذا العلم، حيث تناول في هذه المنظومة شروط البخاري، وتقسيمه للأحاديث، وترتيب أبواب الجامع، وترجمة رجاله؛ معتمدا على فتح الباري لابن حجر العسقلاني.
وبجانب هذه العلوم، أيضا، فقد ألف الشيخ عبد الله في فروع العلوم الإسلامية الأخرى... وكل ذلك يشير إلى ريادة هذا العالم الإفريقي الكبير في مجال التأليف والكتابة، فهو، وفقا لعمر أحمد سعيد، كاتب كبير قلّ أن يوجد مثله في تلك المنطقة (غرب إفريقيا)، بل إنه لعلى يقين تام بأنه قد لا يوجد كاتب مثله في تلك الفترة حتى في المشرق العربي، وذلك لغزارة علمه، وسعة وكثرة إنتاجه، وتنوع علومه وموسوعيته.
إن المؤلفات المختلفة للشيخ عبد الله بن فودي، ما يزال أغلبها رهين المحابس الثلاثة: دور الوثائق، وخزانات بعض الأسر، وبعض أقسام مكتبات الجامعات في عدد من الدول. السودان على سبيل المثال لا الحصر، توجد فيه وفرة لمخطوطات الشيخ عبد الله بن فودي، إذ تحتضن دار سلطان مايرنو، بمدينة مايرنو، جنوب سنار المدينة التاريخية المعروفة، نماذج معتبرة لمؤلفات الأسرة الفودية، تأتي ضمها مخطوطات الشيخ عبد الله، وكذلك يشتمل قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية في جامعة إفريقيا العالمية، على عدد من المخطوطات الخاصة بتلك الأسرة، ولعل من ضمن المخطوطات الخاصة بالشيخ عبد الله: "منظومة مفتاح التفسير"، و"الشفاعة فيمن خرج عن الطاعة"، و"مصالح الأنام بتعظيم الله نبينا عليه السلام"، و"مصالح الإنسان المتعلقة بالأديان والأبدان"، وغيرها كثير. وكل هذه المخطوطات تنتظر من يقف عليها بالدراسة والتحقيق.
الشيخ عبد الله بن فودي وعلم التفسير:
يفهم من تم عرضه سابقا- أن علم التفسير من العلوم الإسلامية، التي أسهم الشيخ عبد الله في التأليف فيها، ومن ثم نشرها، إسهاما كبيرا، وعلى مستويات مختلفة من طلابها.
وفي سياق هذا العلم- يشير الشيخ عبد الله في "إبداع النسوخ" إلى علم التفسير باعتباره من العلوم، التي تلقاها عن أخيه الشيخ عثمان بن فودي، وأنه نهل من معين أخيه في مجال هذا العلم، حتى ارتوى:
ومن علم تفسير وعلم تصوف سقاني فروّى والحساب المقربي
يلاحظ أن الشيخ عبد الله أشار في هذا البيت إلى ثلاثة علوم تلقاها في بداية حياته، وتكوينه العلمي على يد أخيه الشيخ عثمان، هي: علم التفسير، الذي نحن بصدده، وعلم التصوّف، وعلم الحساب البسيط.
على الرغم من أن الشيخ عبد الله يعتبر علم الشريعة هو علمه الأول، ومجال تخصصه الرئيسي- فإن إسهامه في مجال التفسير كان في الحقيقة إسهاما كبيرا لا يقل عن إسهامه في مجالات الشريعة، إن لم يكن أكبر منه. وذلك لأسباب، أهمها: أن الشيخ عبد الله له اهتمام خاص بعلوم العربية... ويعتبر تفسير القرآن بكل المقاييس أقرب العلوم الإسلامية إلى علوم اللغة العربية، لما يتخلله من نظر إلى علوم البلاغة والنحو والقراءات. ثم إن الشيخ عبد الله كان له اهتمام خاص بتعليم الطلاب وإلقاء الدروس عليهم في المراحل الأولى، ثم تصنيف الكتب، التي تعينهم على فهم العلوم المختلفة.
وفقا لمحقق كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"- ثاني محمد أياغي- فإن الشيخ عبد الله بن فودي خلف في تفسير القرآن الكريم ثلاث مؤلفات، هي:
١- نيل السول من تفاسير الرسول.
٢- ضياء التأويل في معاني التنزيل.
٣- كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن.
أما الكتاب الأول: "نيل السول من تفاسير الرسول"، فقد جمع فيه الشيخ عبد الله ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، أخذه عن الإمام السيوطي.
وأما الكتاب الثاني: "ضياء التأويل في معاني التنزيل"- فيقع في ٤ أجزاء كبيرة، جمع فيها الشيخ عبد الله تفسير القرآن بأكمله، كما فعل علماء التفسير المسلمون مثل: الرازي، والبيضاوي، وغيرهما من أصحاب التفسير بالرأي.
يقول الشيخ عبد الله، عن سبب تأليف الكتاب الثاني في مقدمته: "وبعد، فهذا لما اشتدت إليه حاجة الراغبين، وإلحاح الملحين أن أكتب لهم تفسيرا يفهمون به كتاب الله، مع الاعتماد فيه على أرجح الأقوال، بإعراب ما يحتاج إليه الإعراب منه، والتنبيه على القراءات المشهورة في البلاد الهوسوية والسودانية، وبيان الأحكام، والتنبيه على ما يتعلق جنابيب بالبلاغة- فأجبتهم ذلك راجيا من الله تيسيره، وثوابه، وسميته "ضياء التأويل في معاني التنزيل".
وأما كتابه الثالث "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، وهو تليخص لكتابه الثاني- فسنفرد له محورا خاصا في هذا المقال.

ومن مؤلفات الشيخ عبد الله في التفسير وعلوم القرآن- غير التي أوردها ثاني محمد أياغي، محقق كتاب: "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن": "مفتاح التفسير"، وهو كتاب منظوم تزيد أبياته على سبعمائة، نظم فيه علوم القرآن، التي أوردها السيوطي في كتابيه: "الإتقان"، و"النقاية" بالنثر. فبدأ بالإلهيات والنبويات ثم السور المكية، فالمدنية، فالآيات الصيفية والشتائية، فالفراشية والنومية، ثم القراءات السبع، وألفاظ الرواة، والوقف، والإمالة، والمد، والقصر، والإدغام، والتحقيق، والناسخ والمنسوخ، وإعجاز القرآن، وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن الكريم، وقد افتتحه بالأبيات التالية:
الحمد لله الذي أنزلا على محمّد كتابا شملا
كل الفنون من علوم الدين مبينا أدلة التعيين
صلى عليه الله مع صحابته وتابعيهم مع محبته
ويرى عمر أحمد سعيد أن هذه المنظومة (ذات الاثنين والمائتين وألف بيت) تعد من أجلّ إسهامات الشيخ عبد الله في مجال ثقافة القرآن وتفسيره؛ وذلك لأسباب منها: أنه ارتكز فيها على كتابين من أهم كتب علوم القرآن، هما: "الإتقان في علوم القرآن"، و"النقاية" للإمام السيوطي، الذي حشد في كتابيه كل ما يمكن أن يحتاج إليه المسلم من ثقافة تتعلق بكتاب الله... ثم أن الشيخ عبد الله قد صاغ هذه المعلومات في نظم ميسر، الغرض منه تعليم الطلاب، وإشاعة هذه العلوم شعرا ليسهل حفظها على طالبها، وتأليف المتون نظما بغرض الحفظ، كانت هي العادة الغالبة في التعليم في القرون الماضية، وقد تلاشت أو كادت بفعل أنظمة التعليم الحديثة، وبقيت تلك العادة منتشرة في القرى البعيدة والدهليز التقليدية، التي ما تزال تحافظ وتحرص عليها.
ومن إسهامات الشيخ عبد الله في هذا المجال- "الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة"، وقد نظم المؤلف في هذا الكتاب علوم القرآن الكريم، التي أوردها الشاشوي في كتابه بالنثر، وقسّمه في سبعة فصول: ما يختص بترتيب سور القرآن، وفيما يختص بالقراءات، وبكتابته، وبتعليمه، وفيما ما يتعلق بأحوال حامله، وفيما يتعلق بأحوال القرآن من محكم ومتشابه، وبيان فضله. وقد افتتحها بالأبيات التالية:
الحمد لله العليم المنزل خير كتاب لخير مرسل
وخصنا بكوننا من أمته وناصرين دائما لملته
صلاته مع السلام دائما عليه مع أصحابه وعمما
وتقع هذه منظومة الفرائد الجليلة في خمسمائة بيت تقريبا، أشار إليها علي أبو بكر، إضافة إلى علوم أخرى لم ترد في مفتاح التفسير، ويقول في هذا النظم:
وبعد فالقرآن بحر زاخر والعلماء فلكه المواخر
كل الفنون منه تستمد وكل ما خالفه فرد
وعلى ذلك يمكن القول إن للشيخ عبد الله بن فودي- العديد من المؤلفات في علم التفسير (وعلوم القرآن)، الذي تعلمه، ابتداء، من أخيه الشيخ عثمان، منها ما هو منثور، ومنها ما هو منظوم. ويلاحظ في هذا المجال، الذي أسهم فيه الشيخ عبد الله إسهاما بارزا- أنه كان في بعض الأحيان يؤلف الكتاب في تفسير القرآن تأليفا مباشرا، وفي أحايين أخرى ينظم شعرا، ما ألّفوه علماء آخرون في علوم القرآن نثرا. كل ذلك من أجل تقديم خدمة لطلابه في سبيل فهم أمثل للقرآن الكريم وعلومه.
الشيخ عبد الله بن فودي وكتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن":
تمت الإشارة من قبل إلى أن كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، هو تلخيص لكتاب أكبر منه وأشمل، وأكثر تفصيلا في تفسير كتاب الله، وهو "ضياء التأويل في معاني التنزيل". وقبل أن ندخل في تفاصيل تخص كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، الموضوع الرئيس لهذا المقال- نرى أنه يتحتم علينا عقد مقارنة سريعة مع كتاب "ضياء التأويل في معاني التنزيل"؛ وذلك بغرض الوقوف على بيان العلاقة بينهما، تشابها واختلافا.
يمثّل "ضياء التأويل في معاني التنزيل" و"كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان تفسير القرآن"، كتابين في تفسير القرآن الكريم، يقع الأول في أربعة أجزاء، وهو الأكبر. أما الثاني فهو ملخص للأول، ويقع في جزأين بعد دراسته وتحقيقه.
ينتمي التفسيران إلى قسم واحد من الأقسام الخمسة، التي تنتمي إليها مذاهب التفسير الإسلامي. فالمؤلف لم يفسرهما في ضوء التمدن الإسلامي؛ لأن لفظة التمدن لا تنطبق على الحالة، التي كانت سائدة في البلاد في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكذلك لم يضعهما في ضوء الفرق الدينية، إذ لم يكن هناك في البلاد شيعة ولا خوارج. وكذلك بالرغم من أن المؤلف كان صوفيا، فإنه لم يؤلفهما في ضوء التصوف الإسلامي؛ لأنه لم يكن طموحا في تصوفه، ولا مغاليا إلى مرتبة ابن عربي مثلا، بل كان مجرد مريد متواضع، مخلص لشيخ الطريقة القادرية. ولم يضع التفسير في ضوء مذهب أهل الرأي؛ لأنه كان سنيا من الطراز الأول، وإنما وضعهما في ضوء المأثور والمنقول، وبذا جاء مؤلَّفه بعيدا عن الانحياز.
يكمن الفرق بين التفسيرين المشار إليهما، واللذين وضعهما عبد الله بن فودي- هو أنه أسهب في الأول (ضياء التأويل في معاني التنزيل)، فأورد فيه كثيرا من القصص والأحاديث. كما أشار فيه إلى الخلافات بين المذاهب الأربعة في تفسير بعض الآيات، وتعرض لذكر القراءات السبع. أما في الثاني (كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان تفسير القرآن) - فقد أوجز، فلم يتعرض إلا لقراءة نافع على رواية ورش؛ لأنها هي القراءة المنتشرة في السودان الغربي. وكذلك اقتصر على ذكر مذهب مالك وحده لنفس السبب.
إن هذا الكتاب الملخص، الذي نستهدفه في هذا المقال (كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان تفسير القرآن)، يأتي ضمن مؤلفات قليلة للشيخ عبد الله بن فودي، التي حظيت بالدراسة والتحقيق- فهذا الكتاب المطبوع (في جرأين)، الذي بين أيدينا، في الأصل رسالتان علميتان قدمتا لنيل درجة الماجستير في التفسير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم. حقّق الطالب: ثاني موسى أياغي الجزء الأول منها، وحقّق الطالب: حامد إبراهيم حامد الجزء الثاني، وهما طالبان نيجيريان. وقد تمت مناقشة رسالتيهما عام ٢٠٠٢. وقد منح الباحثان درجة الماجستير بتقدير ممتاز لكل منهما، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالتين. ولكن إعداد الكتاب للنشر في صورته النهائية، دراسة وتحقيقا، قام به مؤلف الجزء الأول، ثاني موسى أياغي، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه، وقد نشرته دار الأمة بكانو-نيجيريا، دون الإشارة إلى تاريخ محدد في تلك الطبعة.
هناك جدل حول اسم هذا الكتاب، وعنوانه "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، نصّ على ذلك المؤلف في مقدمة الكتاب، وهو مطبوع أيضا على غلاف جميع المخطوطات، التي وقف عليها محقق الكتاب. وقد ورد في كتاب "الثقافة العربية في نيجيريا" لعلي أبو بكر أنه أضاف "أهل" قبل السودان. كما وجد على غلاف الكتاب المطبوع من مكتبة الحديثة، بيروت، لبنان- أن اسمه "كفاية أهل الإيمان في تفسير القرآن"، والذي يظهر أن هذه التسمية تجارية، هدفها لفت أنظار الراغبين إلى اشتراء الكتاب، لكأن أصحاب هذه المكتبة لاحظوا أن في تسمية كفاية ضعفاء السودان نوعا من الثقل، بل وتوجيها إلى مجموعة من البشر بعينها.
ما سبب تأليف الكتاب؟ لا بد من الإشارة أولا إلى أن الكتاب لم يؤلف تأليفا، كعادة تأليف الكتب، وإنما هو تلخيص لكتاب آخر أكبر منه حجما، أغزر منه مادة، كما ذكرنا من قبل. لذلك نرى أن يعدّل السؤال السابق إلى ما سبب هذا التلخيص؟
يقول الشيخ عبد الله بن فودي في مقدمة "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن: "لما منّ الله عليّ بإكمال تفسير "ضياء التأويل في معاني التنزيل"، وكان حافلا ببيان القراءات السبع، وبيان أقوال الأئمة الأربعة في الفروع، وبيان العربية والبلاغة والأصول، وترتيب الغزوات والسرايا، وغير ذلك مما لا يعرفه إلا من طالعه مستحضرا لما فيه، فضعف عنه لذلك الضعفاء- صرفت الهمة إلى تلخيص لهم، مبينا على رواية ورش فقط، وعلى مشهور مذهب مالك، وعلى ما لا بد منه من علوم العربية والبلاغة والقصص، وسميته بكفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن".
ويبدو واضحا من كلام الشيخ عبد الله أنه قام بهذا التخليص، لما رآه من أن عوام الناس في بلاد السودان، الممتدة من الهضبة الإثيوبية إلى المحيط الأطلسي، جنوب الصحراء الكبرى مباشرة، لا يقدرون على فهم ما جاء فيه، لما فيه من بسطة من الشرح والتفصيل والإسهاب، الذي يحتاج إلى مستوى فكري متقدم؛ لذلك سعى، بتقدير المعلم الحصيف، الذي يدرك حاجات طلابه- إلى اختصار الكتاب (ضياء التأويل في معاني التنزيل) في مؤلف مبسط سهل، يوافق مستوى عامة الناس العقلي، وكأنه من خلال عنوان الكتاب الملخص (كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن) يقدم ما يكفي عامة الناس، الذين خصّهم بوصف ضعفاء السودان، ليبقى المؤلف قبل تلخيصه كتابا لخاصة الناس؛ ممن تقدموا العامة فكرا وعلما.
أما فيما يخص مصادر الكتاب الملخص (كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن)- فقد اعتمد الشيخ عبد الله بن فودي في تأليفه، لهذا الكتب التفسيري على أمهات كتب التفسير المعتمدة، والمصنفات في علوم القرآن، وكتب الحديث، ومصادر الفقه المالكي، وكتب اللغة والسيرة وغيرها، ذكر منها ثاني موسى أياغي، محقق الكتاب ثلاثين كتابا مصدريا، رأى أنها من أهم المصادر، التي رجع إليها الشيخ عبد الله، منها: "جامع البيان عن تأويل القرآن" للإمام الطبري، و"زاد المسير في علوم التفسير" لابن الجوزي، و"أحكام القرآن" لابن العربي، و"الخلاصة" لابن مالك، و"مختصر خليل"، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي، و"سيرة ابن هشام".
ويرى علي أبو بكر، مؤلف كتاب "الثقافة العربية في نيجيريا"؛ أنه "ليس هناك من شك في أن المفسر (الشيخ عبد الله)- قد استعان بكتاب الطبري الكبير في تفسير القرآن؛ لأنه كثيرا ما ذكره، واستدل بما فيه من تفسير آيات كثيرة؛ مما يجعلنا نقطع بأنه وضع التفسيرين (ضياء التأويل وكفاية ضعفاء السودان) في ضوء المأثور، فضلا عما صرّح به. ولكن ذلك لا يعني أنه لم يستعن بتفاسير أهل الرأي، إذ إن هناك دلائل تشير إلى استعانته بكتاب "الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل" للزمحشري، خصوصا في شرحه للنقاط، التي تتعلق ببلاغة القرآن وإعجازه؛ لأنه كثيرا ما استدل بما ورد فيه، وبما ورد في البيضاوي أيضا".
وأما فيما يخص المنهج، الذي اتبعه الشيخ عبد الله في تأليف الكتاب- فإنه قد اتبع منهجا محددا، تتجلى أسسه في التقاط التالية:
١- يفتتح السورة دائما ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يضع الآية المراد تفسيرها بين قوسين ( )، ثم يشير إلى التفسير اللغوي، والأحكام الشرعية في الآية، إن وجدت.
٢- يشير إلى السورة أهي مكية أم مدنية، وعدد آياتها.
٣- يذكر أحيانا أسباب نزول الآيات أو الآية.
٤- يستشهد بالأمثال العربية؛ لبيان معنى لغوي للآية.
٥- يشير إلى الأحكام الفقهية، مبينا مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه.
٦- يستدل أحيانا لتوضيح معنى آية بآية أخرى.
٧- يذكر المعنى اللغوي للآية إذا كان خفيا، ويتعرض للإعراب إذا تضمن بيان ذلك.
٨- يتعرض لمعاني الحروف النحوية، ويشير للخلاف النحوي، إذا ترتب عليه بيان معنى.
٩- يشير إلى النكت البلاغية أحيانا.
١٠- يحيل أحيانا تفسير الآية المتقدمة عليها في المعنى.
وأما فيما يخص القيمة العلمية لكتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"- فيرى عمر أحمد سعيد، أن الشيخ عبد الله بن فودي- استطاع أن يوظف ثقافته الواسعة من العلوم والفنون الإسلامية توظيفا حسنا في هذا الكتاب. ولهذا جاء كتابه زاخرا بأنواع العلوم والفنون العربية منها والإسلامية، مما يجعله بكل المقاييس إسهاما كبيرا في هذا المجال؛ مجال تفسير القرآن الكريم.
علاوة على ذلك يمتاز كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن" بسلاسة الأسلوب، وبساطة العبارة، وعذوبة الألفاظ، وسهولة المتناول مع جودة السبك، وإتقان السلك... ويعتبر هذا الكتاب من كتب التفسير، التي جمعت بين التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي المحمود في آن واحد. وهذه الميزة قلما توجد في كتاب بمثل هذا الحجم... وهذا الكتاب في الغالب يعتبر خاليا من الحشو والتطويل والقصص الضعيفة والموضوعة، التي يكثر منها كثير من المفسرين في كتبهم. ولهذا الكتاب ميزة أخرى، وهي أنه يشير إلى الأحكام الفقهية من خلال استنباطها من الآيات القرآنية. وبهذا يعتبر كتاب فقه مبني على الدليل الشرعي... ويتمتع هذا التفسير بتقدير كبير بين علماء نيجيريا على وجه الخصوص، وبين علماء غرب إفريقيا على وجه العموم، حتى بلغ من تقدير بعضهم له أنه لا يفسر القرآن إلا به، أو بأصله "ضياء التأويل في معاني التنزيل.
وأخيرا، يمكن القول إن كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"- منتشر ومتداول بين الناس في جميع أنحاء نيجيريا، وسائر بلاد غرب إفريقيا، لما له من قيمة علمية، ومكانة مرموقة بين مسلمي إفريقيا، وذلك يرجع إلى مكانة مؤلفه، ودرجته المعروفة لدى الجميع. ومع هذا كله فإن الكتاب منشور ومذاع بدون تحقيق. فكلّ من يريد امتلاكه، فإما أن يجده مخطوطا أو مطبوعا بدون تحقيق. هذا قبل أن تظهر نسخته، التي بين أيدينا، مدروسة محققة، ومطبوعة بحيث تسهل الاستفادة منها، بصورة أكثر سعة وانتشارا.
ويفهم من ذلك أن كتاب "ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن" للشيخ عبد الله- جاء تلخيصا لكتابه الأكبر والأشمل والأغزر مادة "ضياء التأويل في معاني التنزيل"، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وأن الشيخ عبد الله لخّصه ليتوافق مع حاجة العامة لفهم كتاب الله، وقد تميز الكتاب الملخص بأنه خلا من الحشو والتطويل والقصص الضعيفة، وأنه حوى أسلوبا سلسا، وبساطة في العبارة، وعذوبة في الألفاظ؛ مما جعله ينتشر في بلدان غرب إفريقيا عموما، ونيجيريا على وجه التحديد، يعزز ذلك احتواء الكتاب على الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات القرآنية، التي يحتاج إليها عامة الناس في بلاد السودان.
خلاصة واستنتاجات:
نخلص في هذا المقال، الذي حاولنا من خلاله إلقاء الضوء على بعض إسهام علماء إفريقيا جنوب الصحراء، متخذين من كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن" للشيخ عبد الله بن فودي، نموذجا- نخلص إلى النقاط التالية:
أولا: أن الشيخ عبد الله بن فودي ولد في بيئة وعائلة عرفت بأنها محمل للثقافة الإسلامية، وناشرة لها، وأنه تربى وتأدب على يد أخيه الشيخ عثمان، وكان ساعده الأيمن، وصديقه الوفي. كما يلاحظ تعدد شيوخه، وتعدد مصادر ثقافته، وأن الشيخين عثمان وجبريل يعدان أهم قطبين كونا شخصيته، وخلفيته العلمية، والروحية. وأنه كان حريصا على التعلم، بحرصه على التواصل مع شيوخ مختلفين علما وبيئة؛ لذلك تكونت له شخصية ثرة في مجالات اللغة العربية والعلوم الإسلامية، مما انعكس ذلك على تنوع إنتاجه العلمي، وغزارته.
ثانيا: أن الشيخ عبد الله بن فودي اتصف بكثرة المؤلفات وتنوّعها، وشمولها لمعظم فروع العلم والمعرفة في عصره، حتى بلغت نحو ١٧٠ مؤلفا من كتاب ورسالة، وبحكم مذهبه المالكي- جاءت مؤلفاته متأثرة، كغيره من علماء غرب إفريقيا- بعلماء المذهب المالكي، خاصة المغاربة. على أن مؤلفات الشيخ عبد الله تنتظر الغالبية الغالبة منها، الدراسة والتحقيق؛ لأنها ما تزال عبارة عن مخطوطات محفوظة هنا وهناك.
ثالثا: أن الشيخ عبد الله بن فودي أفرد حيزا معتبرا من مؤلفاته لعلم التفسير وعلوم القرآن، فجاءت بعض تلك المؤلفات منثورا، ووجاء البعض الآخر منظوما. وأنه تعلم هذا العلم في بداية حياته من أخيه الشيخ عثمان. وأنه في تأليفه لبعض كتب التفسير كان يراعي مقام طلابه، لذلك جاء بعضها للعامة، وجاء بعضها الآخر للخاصة، ممن هم في درجة أعلى في الفكر والوعي. وأنه أبرز قدرة كبيرة في تأليف كتب التفسير نثرا، ومهارة عالية في نظم كتب العلماء الآخرين شعرا.
رابعا: أن الشيخ عبد الله بن فودي قام بتلخيص كتابه "ضياء التأويل في معاني التنزيل"، الذي جعله الخاصة من الناس- إلى كتابه "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"، ليتناسب وعامة الناس، ممن يمثلون السواد الأعظم من سكان بلاد السودان. وقد أوضح هذا الكتاب، الذي بناه على أمهات كتب التفسير المعتمدة، والمصنفات في علوم القرآن، وكتب الحديث، ومصادر الفقه المالكي، وكتب اللغة والسيرة- أوضح ثقافة المؤلف الواسعة في العلوم والفنون الإسلامية.
وأخيرا، يمكن القول إن كتاب "كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن" للشيخ عبد الله بن فودي يعد إسهاما معتبرا من إسهامات علماء إفريقيا جنوب الصحراء، وآية ذلك أن هذا الكتاب، الذي يخلو من الحشو والتطويل والقصص الضعيفة والمصنوعة- كتب له الذيوع والانتشار منذ تأليفه، وحتى يوم الناس هذا في بلدان غرب إفريقيا عموما، ونيجيريا على وجه الخصوص. إضافة إلى أن كاتب هذا المقال على علم بأن رسالتي دكتوراه في جامعتين سودانيين مختلفتين تناولتا موضوعات تتعلق بهذا الكتاب.